عندما نمعن الاستماع والنظر في الخطاب الشعبي السائد في مجتمعاتنا العربية، فإننا نمسك بسهولة كبيرة بأهم مُسببات التأزم العربي، ونتعرف إلى الخلل الحقيقي الذي يحول دون تغير طرائق التفكير.
ولعل مواقع التواصل الاجتماعي بوابة مهمة تمكننا من التلصص على تمثلات مجتمعاتنا وتصوراتها، التي تمثل لنا معطيات للقياس وللفهم.
نتصفح شبكات التواصل الاجتماعي هذه الأيام فإذا بأصوات تعبر عن تحسرها على زمن معمر القذافي، ونحتك بالناس في الفضاءات العمومية التونسية، فنسمع ما يشير صراحة إلى حنين لزمن زين العابدين بن علي…
إن هذا الحنين إلى زمن ما قبل الثورات، الذي ما فتئ يتكرر، يستحق منا وقفة تفكير؛ لأنه مؤشر خطير جدًا، ويدل على أن مجتمعاتنا ما زالت تحتكم إلى الانفعالية، وتفتقد إلى حدّ كبير إلى العقلنة في تقويم الأوضاع.
طبعًا هذا الحنين الصادم لأنصار الثورة هو في النهاية نتاج إخفاق الثورات العربية في تقديم البدائل، وفي تحسين ظروف الناس. وفي المثال الليبي رأينا كيف أن البلد تحول إلى ملجأ للإرهابيين ولأكثر التنظيمات التكفيرية عنفًا، وأيضًا اضطرار أعداد كبيرة من الليبيين إلى العيش في المنفى هربًا من مأساوية الأوضاع.
صحيح أن كل البلدان العربية التي عرفت ثورة تعيش صعوبات أمنية واقتصادية جمّة، ولكن هل يعني تراجع الأوضاع وتأزمها في مرحلة ما بعد الثورة أن نمجد مرحلة ما قبل الثورة، وإعلان اليأس التام، وإفراغ الحاضر من كل بارقة أمل؟
يبدو لنا أنه بمثل هذا الحنين كمن يُفاضل بين الأخطاء، وهي مفاضلة تفتقد إعمال العقل والمنطق.
لذلك؛ فإنه مهما يبدو الوضع الحالي سوداويًا ومفجعًا، من المهم أن نتحلى بالقدرة على التمييز وعلى التوصيف الدقيق والعقلاني للأشياء. فالخطأ خطأ. والوضع السيئ يظل سيئًا حتى لو وقعنا بعده فيما هو أسوأ. يجب أن نُعود أنفسنا على النقد الواضح، وألا نخلط الأشياء بشكل يكشف عن خمول ذهني ورغبة في تفسير الوقائع بأكثر التفسيرات سهولة وراحة للنفس.
فالعقل الذي يعمل استنادًا إلى المنطق يدرك أن الثورة، بلفت النظر عن حيثياتها وما إذا كانت ربيعًا أو خريفًا، إنما هي صيحة احتجاج تستحق الجدية في القراءة وفي الفهم والتفهم. كما أن ما عرفته بلدان الثورات العربية من انتكاسات متتالية وعميقة يجب عدم التعاطي معه بصفته نتيجة عكسية من نتائج الثورة؛ بل لأن إدارة مرحلة ما بعد الثورة هي التي كانت سيئة، وأدت إلى ما آلت إليه الأوضاع من خيبات.
قد تبدو لنا هذه الجزئيات في بادئ الأمر غير مهمة، ولكنها مع الأسف متحكمة في عملية التفكير وضاغطة عليها مما جعل منها عائقًا للتفكير العقلاني الذي وحده يُمكننا من دقة الفهم والتشخيص؛ حتى نستطيع التجاوز والتقدم نحو الأمام في الإصلاح والتنمية والديمقراطية والحريات الأساسية والعامة التي تطمح لها مجتمعاتنا.
يجب ألا نُفاضل بين السيئ والأقل سوءًا والفساد والأقل منه فسادًا وبين الخطأ والخطأ.
ولكن كيف يمكن تهيئة العقل الاجتماعي الشعبي على هذه العقلنة في تقويم الثورة وما قبلها وما بعدها؟
إن هذه المشكلة ذات الصلة بكيفية إدراك حدث الثورة في معناه العميق والفكري، هي نتيجة حتمية وطبيعية جدًا للتغييرات التي عرفتها المنطقة العربية دون أن تستند هذه التغييرات إلى أرضية ثقافية صلبة. فلقد كانت تغييرات مفاجئة ومباغتة.
طبعًا لا ننكر أنه في الأسابيع الأولى لما بعد الثورة ارتفع منسوب الأمل والحرية؛ وهو ما جعل بعض المراقبين يصفون ذلك بالربيع العربي. وكان بالإمكان استثمار حالة الاستعداد النفسي والذهني العربي لحدوث ثورة على مستوى العقل وطريقة التفكير والتقويم. ولكن ما حصل هو العكس؛ ضاعت حالة التوهج الشعبي وعوضت بالإحباط: فقر أكبر وبطالة أعم، وفساد مكشوف وتحالفات مفتوحة، ومكاسب اهترئت وبنية تحتية انهارت في ليبيا، ومكاسب المشروع التحديثي التونسي ضربت في مفاصل حساسة مثل التعليم والصحة… وفي كل يوم في مصر نسمع فتاوى التكفير وعمليات إرهابية…
لقد هدرت النخب حالة الاستعداد النفسي والذهني لتطوير العقل العربي وتغيير محدداته واستبدال أخرى عقلانية بها. ونقصد النخب الفكرية وبشكل أساسي النخب السياسية، التي منعها جوعها للحكم وتعطشها التاريخي للمشاركة السياسية من إنجاح المرحلة واستثمار اللحظة التاريخية. وبالاستسلام إلى مرض حب السياسة لأطماع شخصية ضيقة سقط الحلم وظهرت النخبة السياسية في حال أحيانًا أسوأ من النخب التي كانت تحكم ما قبل الثورة.
مؤسف أن يتحسر الكثيرون على أزمنة ما قبل الثورة، وأن تتزايد من خيبة إلى أخرى ظاهرة شيطنة الثورة… والأكثر أسفًا أن نُقارب ذلك من منظور انفعالي يُفاضل بين الأكثر سوءًا والسيئ.

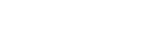











أضف تعليق