على مدى أكثر من عقود ثلاثة، ومنذ ما اصطلح على تسميته “أزمة المناخ” اتسم المشهد الاقتصادي والسياسي في الكويت بظاهرتين اثنتين، أولاهما، تأزم مستمر ومتصاعد في الممارسة الديمقراطية، والثانية، اختناقات عميقة ومعوقة للعملية التنموية.
وعلى مدى العقود الثلاثة هذه، ثبت بالتجربة المكلفة والمتكررة أن بين الظاهرتين ارتباطاً عضوياً وثيقاً يجعل من العبث التعامل مع أي منهما بمنأى عن الأخرى، فالتأزم السياسي أصبح أخطر ما يهدد جهود التنمية، والقصور التنموي أصبح أهم أسباب التأزم السياسي في بلادنا. وبالرغم من الأسباب “الرسمية” المعلنة لحل مجلس الأمة السابق، أزعم أن “الضياع السياسي” الواضح في معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة الراهنة كان من أهم دوافع هذا الحل. كما أزعم أن مجلس الأمة الجديد سيعاني من “صدام الظاهرتين” ما لم يسجله أي من المجالس السابقة على الإطلاق. وهذه الحقيقة بالذات هي التي أملت عليّ هذا المقال، ليس من قبيل الادعاء بامتلاك الحلول، بل على سبيل التذكير ببعض الشروط الواجب توفرها أملاً بالوصول إلى المعالجة الناجحة والعادلة، وخاصة أننا على أبواب إعلان حكومة جديدة، سيمثل تشكيلها – بالتأكيد – أولى بشائر الانفراج، أو بداية تحرك الرمال تحت خطوات مجلس الأمة والحكومة معاً.
وهنا لا أنكر أبداً أنني أتهيب المطالبة بتشكيل حكومة بأسلوب وطني وموضوعي سليم يبتعد ابتعاداً جذرياً عن الأسلوب الحالي، ذلك لأن مثل هذا التحول الأساسي والمطلوب يحتاج إلى إرهاصات فكرية، وإعداد اجتماعي على مدى زمني غير قصير. غير أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فلا أقل – إذن – من الدعوة إلى حكومة تعكس نتائج الانتخابات بحيث تكون لها كتلة برلمانية واضحة القوة والتأثير تؤمن دعم قراراتها، وتحفظ لها حداً أدنى من الديمومة والاستقرار.
وحكومة من هذا القبيل يجب أن تكون المهمة الرئيسية لوزرائها داخل مجلس الوزراء لا خلف مكاتب وزاراتهم. فالمنصب الوزاري منصب سياسي وليس منصباً فنياً. ودون الإقرار بذلك والعمل بموجبه، ستبقى حكوماتنا تصرف الأمور (ولا أقول تديرها) تبعاً لضغوطات اللحظة وحسب نجاحها أو إخفاقها في تأمين الدعم الكافي لقراراتها، علماً بأن إعطاء “الوزير” دوره السياسي الصحيح سيشجع الكثيرين ممن يعزفون الآن عن المنصب الوزاري على الإقبال على هذا التكليف. ومع وجود وزراء من أصحاب المصداقية الوطنية ومن هذا المعيار، يمكن أن نحقق نجاحاً افتقدناه طويلاً في مجال احترام الفصل بين السلطات، وفي مجال اتخاذ القرارات الصعبة التي ستجد – رغم صعوبتها – تجاوباً وطنياً شعبياً إذا اقترنت بالتوعية اللازمة والمصارحة الصادقة.
ورغم الدور التشريعي والرقابي لمجلس الأمة، تبقى مهمة بناء تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى، وخاصة أنها تشكل أكبر كتلة ثابتة في مجلس الأمة، وبالتالي، يجب أن تتحلى الحكومة بكثير من الحكمة والصبر ومن الدبلوماسية وسعة الصدر، لتعزيز جسور التعاون المطلوب، فلا تضيق بكل رأي معارض، ولا تضغط بأساليب المنع والمنح، دون أن تتهاون أبداً في التمسك بصلاحياتها الدستورية التي تؤهلها للنهوض بمسؤولياتها.
وفي الجانب البرلماني، يحتاج العمل النيابي نفسه إلى إصلاح شامل وعميق ليعود إلى أصوله وأصالته، حيث الترفع عن كل ما هو هامشي وضيق وخاص لمصلحة الأهداف العامة والمصالح الوطنية، وحيث الإنجاز هو المقياس، واحترام الرأي الآخر وصاحبه هو الأساس، والحوار الراقي هو الأسلوب، وعلى ممثلي الشعب أن يذكروا دائماً أن السياسة فن الممكن، وأن قواعد العمل النيابي تجعل من غير الممكن ومن غير المفيد أن يحصل أحد الأطراف على كل ما يريد في الوقت الذي يريد. وروح الممارسة النيابية تتجلى في الاتفاق على حق وحدود الاختلاف، فلا استئثار ولا إقصاء، والديمقراطية ليست حكم الأكثرية فقط، بل هي – بنفس القوة – احترام حقوق الأقلية أيضاً. إن قوة مجلس الأمة لا تقاس بعدد استجواباته ولا بكثرة تحقيقاته، ولا حتى بحجم تشريعاته، بل هو المجلس الذي يستطيع أن يحدد المصلحة العامة بعمق ونفاذ ويشرع بحكمة لتحقيقها، وهو المجلس الذي يساند الحكومة في جهودها، ويراقبها في عملها، ثم يسائلها على أدائها، وهو الذي يحرص على نوعية التشريعات وعدالتها وكفاءتها أكثر من حرصه على عددها، وهو المجلس الذي يرقى بخطابه إلى مستوى مكانته، ويعرف متى يستجوب ولماذا وكيف، فلا يتعسف في استعمال هذا الحق النيابي الإصلاحي في غير وقته وموضعه وغايته، وهو المجلس الذي لا يكتفي برفض مقترحات الحكومة بل يطرح بدائلها، ولا يكتفي أعضاؤه بإطلاق الشعارات بل يؤكدون على المضامين في الآليات.
وإذا كان من الصعب أن ننكر ما اعترى العمل البرلماني خلال العقدين الماضيين من تشتت للجهود في مسائل هامشية على حساب القضايا الأساسية، فإن هذه الظاهرة -على خطورتها- يجب ألا تنزلق بنا إلى محاذير التعميم والحكم على دور مجلس الأمة من خلالها، فالتقييم والتقويم يجب أن يتناولا مواقف وأداء النواب كأشخاص، دون أن يمتدا إلى دور المجلس كمؤسسة تمثل ركناً أساسياً من أركان نظامنا الديمقراطي لا غنى عنه، ولا جدال في أن أي إضعاف له هو إضعاف للحكم والشعب والوطن.
وأخيراً، إن الديمقراطية لا تختزل بصناديق الاقتراع، وإذا انفصلت نتائج صناديق الاقتراع عن تطلعات التنمية وعدالتها تفقد العملية الديمقراطية شرعيتها التنموية والاجتماعية، وتنقلب إلى وسيلة عقيمة أو منهج بلا هدف. وبالتالي، يجب أن نقرأ نتائج الانتخابات الأخيرة قراءة واعية صحيحة دون أن نتخوف منها ودون أن ننبهر بها لكي نستطيع العمل على إحداث التغيير الذي يقتضيه احتواء هذه التحولات، في إطار الشرعية والدستور، على اعتبار أن التغيير الهادئ المستنير هو الضمانة الحقيقية لتحقق متلازمة الاستقرار السياسي والنجاح التنموي.
يملي عليّ الواجب أن أكتب هذا المقال، فيمرّ في خاطري رهط من الرواد الذين أخلصوا وأسسوا ومضوا، وتستعيد الذاكرة القريبة صور أحفادهم الشباب يملؤون الندوات والمقرات والمراكز الانتخابية، تتألق عيونهم بحب الوطن، ويرتسم في نبرتهم الغضب من أجله والغضب على من خذله، فأشعر بثقة مطلقة واعتزاز كبير بأن هؤلاء هم دعاة التغيير وصانعوه، والقادرون -بإذن الله- على استعادة سيرة الرواد تمسكاً بالوطن وتطوراً مع العلم والزمن.
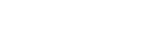












صقر
الصقر مو منحاش من البلد ولا انا غلطان؟!!!