هناك حاجة متجدّدة إلى الإصلاح الإسلامي، لكن السؤال المهم يبقى: من أين يبدأ المصلحون، وما عساها تكون موضوعات إصلاحهم؟
باعتباري ابناً للحضارة العربية/ الإسلامية، وبهذا المعنى، ابناً للإسلام أيضاً، سأسمح لنفسي بدسّ أنفي في هذا الموضوع الحساس، وسأقدم ملاحظات بشأنه، على النحو الذي سأبلوره في أسئلةٍ أرفدها بتعليقات مختصرة:
أولا، ما هو الإسلام اليوم، وهل هناك فهم موحد له، أم أنه توجد قراءات متعدّدة بتعدّد التيارات والمصالح المتضاربة هنا وهناك؟ وإذا كان صحيحا أن النص هو قراءتنا له، وهو أيضا إعادة إنتاجه نصاً لنا، بحسب ما نفهمه منه، وليس بحسب ما هو بالفعل، فإن السؤال يصير: كم فهماً يوجد للإسلام، وبالتالي كم إسلاماً، وما هي الفروق بين الإسلامات القائمة، وكم يبلغ عمق الآراء والمصالح التي فصلت بينها في الماضي، وتفصل بينها أيضا كما في الحاضر، وهو ما حذّر سيدنا علي، رضي الله عنه، أبا موسى الأشعري، منه، حيث حذّره من القبول بتحكيم القرآن في خلافه مع معاوية، قائلا جملته الشهيرة والصائبة: القرآن حمّال أوجه.
والآن: إذا كانت الوسطية سمة إسلام أهل السنة العرب، فهل هي سمة أهل السنة الأفغان والباكستانيين الذين نتبنى اليوم إسلامهم السلفي الجهادي الذي يخرجنا، ويخرج الإسلام من العصر، بينما تمسي حاجتنا وحاجته إلى دخوله، والانخراط بقوةٍ وعمقٍ فيه؟ إذا كان هناك إسلامات بقدر ما هناك من قراءات للإسلام، كما أنه توجد أرسطيات وماركسيات، بقدر ما توجد قراءاتٌ متنوعة إلى حد التناقض بين القراءات الأرسطية والماركسية، يكون أول موضوع في بند الإصلاح الأول هو تحديد ماهية ما نقصده بالإسلام الذي نريد إصلاحه، بالنظر إلى أن إصلاح الإسلام السائد في مجتمع معزول عن العالم ومتخلف وأمي، كالمجتمع الأفغاني، لا بد أن يختلف جذرياً عن إصلاح إسلام مجتمع متقدم وعالمي، كالمجتمع الماليزي؟ في هذه الحالة، ماذا يمكن أن يكون الإصلاح المطلوب، وما معناه، وأين يبدأ ويتوقف، وما هو مآله، وماذا يمكن أن يتمخض عنه؟
ثانياً، من هو المسلم؟ هل هو الذي يقصّ رأس المسلم الآخر وهو ينطق بالشهادتين؟ أم ذلك
المسلم الذي يشتغل في مصنع معلوماتية أميركي، وتقوم عبادته الإسلامية على خدمة البشرية، مع أنه يردّد في صلاته الكلمات التي ينطق بها مسلم الطراز الأول، الذباح، وهو يصلي؟ أم أن المسلم هو الذي يرى نفسه وغيره بدلالاتٍ علمانية، ويعتبر الدين شأناً شخصياً وخاصاً، وعلاقة بين المسلم وربه لا رابطة بينها وبين أية مأسسة دينية، جماعية كانت أو فردية، مستقلة أو تابعة لسلطة. من هو المسلم، إذا كان هؤلاء جميعهم مسلمين، لكنهم لا يتفقون في أي شيء يتجاوز صفتهم البرّانية هذه؟ أعتقد أن علي الوقوف عند هذا السؤال، ووضع تعريفٍ للمسلم الذي تضعه آية قرآنية في مرتبةٍ أدنى من مرتبة المؤمن، بنصها “قالت الأعراب آمنّا، لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم”. في هذه الحالة، لا بد لمسعى إصلاحي أن يجيب على السؤال: هل كل مسلم مؤمن بالضرورة، وهل كل من يسمى نفسه مسلماً هو في الحقيقة والواقع مسلم حقاً، ولماذا يوضع المؤمن بإطلاقٍ في مرتبة أعلى من مرتبة المسلم غير المؤمن؟
ثالثاً، أصل من ذلك إلى حتمية أن يحدّد الإصلاح الإسلامي العلاقة المركّبة بين المسلم والمؤمن والإنسان. في الآية السابق ذكرها، يأتي المسلم في مرتبةٍ أدنى من المؤمن، ففي أية مرتبةٍ يضع القرآن الكريم الإنسان؟
ثمّة في كتاب الله آية كريمة تعيّن هذه العلاقة، هي التي نصها “وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك، ونقدّس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون”. يضع الخالق عز وجل الإنسان في هذه الآية فوق مرتبة الملائكة، ويستخلفه في الأرض بما هو مجرد إنسان، وليس كمسلم أو كمؤمن، والسبب أن الإنسان اسم نوع وليس صفة، وقد يكون أو لا يكون مؤمناً بدين، وقد يعبد أو لا يعبد الله، ولو شاء ربك لاستخلف المسلم أو المؤمن، بيد أنه لم يفعل، واستخلف الإنسان من دون تعريف هويته، كي لا يقيد عموميته، وغض النظر عن صفاته، وفضّله على الملائكة، على الرغم من أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء.
السؤال المهم هنا: لماذا لم يعرّف الله، في محكم كتابه العزيز، الإنسان بدينه، وجعله، كإنسان صرفٍ أو كمحض إنسان، خليفةً في الأرض، ليس فوقه أحد غير الله عز وجل؟ والآن: هل يمكن أن نحدّد علاقة المسلم بالمؤمن بالإنسان في ضوء الآيتين الكريمتين، فنقول: ثمة تراتبية إلهية تضع الإنسان الذي بلا أية صفات غير كونه إنساناً، في أعلى سلم الموجودات، يليه المؤمن الذي تعلو مرتبته على المسلم، لأنه قد يكون غير مؤمن.
ماذا يحدث حين نقلب هذا التراتب، فنضع المسلم فوق المؤمن، وتحتهما الإنسان؟ ألا نقلب بذلك النظام الذي أقرّه الله في قرآنه، وننتهك ما أقره لنا، وهو أن الإنسان لا بد أن يكون مقياس
“لماذا لم يعرّف الله، في محكم كتابه العزيز، الإنسان بدينه، وجعله، كإنسان صرفٍ أو كمحض إنسان، خليفةً في الأرض، ليس فوقه أحد غير الله عز وجل؟” جميع ما في الوجود، كما كان فلاسفة اليونان يقولون، وأن المسلم الذي قد يكون، وقد لا يكون مؤمناً، ليس المستخلف في الأرض، لأنه، إن كان غير مؤمن، يفسد فيها ويسفك الدماء، كما يتهمه الملائكة في الآية الكريمة، وكما يفعل مسلمون كثيرون، غير مؤمنين، في أيامنا.
رابعاً، إذا كان الله يستخلف الإنسان بإطلاق، هل يجوز لمسلم أن يدّعي، بعد اليوم، وجود تناف مطلق بين الإسلام والعلمانية التي ليست أي شيء آخر، غير ما يترتب على هذا الاستخلاف في وجود الإنسان الذي لم يشترط الله لاستخلافه أن يكون مؤمناً أو مسلماً، هل يجوز أن يقفز الإصلاح الإسلامي عن هذه الحقيقة التي تجعل منه إصلاحا إسلاميا وإنسانيا في آن معا، وتمكّنه من بلورة تعريف إنساني لما تعنيه كلمة مسلم، يتفق والبعد الإنساني للإسلام الذي استخلف الإنسان في الأرض، بعد اكتمال رسالته الرحمانية التي يفقدها الإسلام السلفي والجهادي السائد بعدها الإنساني الكوني، بحصرها في المسلمين، وتحويل الإسلام إلى دينٍ لا يكترث بغير هؤلاء، إنْ لم يكن معادياً لسواهم.
خامساً، كان أستاذي إلياس مرقص يتحدّث عن حاجتنا إلى إصلاحٍ أكبر من ثورة. هذا ما يحتاجه الإسلام: ثورة فكرية/ روحية، يُنجزها الإصلاح الإسلامي، سيكون دورها حاسماً في إخراجنا من وثنياتٍ سائدة، جعلتنا، في جانبٍ منها، نعبد بشراً. وفي جانب آخر، نقتتل ونبيد بعضنا بعضاً، باسم الإسلام.
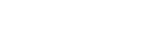




















ما شالله حتى النصارى يفسرون القرآن ??