يشكّل المبدعون في المجالات الفنية والعلمية والفكرية، جزءًا من نهضة البلدان التي ينتمون إليها، ما يدفع حكومات بلدانهم لتكريمهم وتخليد ذكراهم بطرقٍ شتىّ؛ منها تحويل بيوتهم إلى متاحف ومزارات خاصّة. شيءٌ لم تعتد عليه الدول العربية عمومًا وسورية خصوصًا.
في لبنان، تقيم بلدية مدينة بشرّي في الشمال، متحفًا في منزل الأديب اللبناني الراحل جبران خليل جبران، وفرنسا تجمع كل الشخصيات المؤثّرة في تاريخها في مقبرة واحدة تسمّى “البانتيوم”، كما تشير بلافتات طرقية إلى أماكن سكن وعمل مبدعين فرنسيين من كل المجالات، كـ ماري كوري وفيكتور هوغو، تمامًا كما هو الحال في مصر التي تهتم بإرث شخصيات أغنت الفن العربي كأم كلثوم وغيرها، أما في سورية فلم تأبه بلدية دمشق بحال الكثير من بيوت مبدعيها أو إرثهم الفني والثقافي، كحال منزل الشاعر السوري الراحل نزار قباني، والذي تحوّل إلى معرض لـصور الأسد والأمين العام لـ “حزب الله”، حسن نصر الله.
يقع منزل الشاعر نزار قّباني وسط حي مئذنة الشحم في قلب مدينة دمشق القديمة، وعلى مقربة من سوق البزورية الشهير، ومنطقة باب صغير، ولد نزار في آذار/ مارس من سنة، 1923 وهناك عاش فترة طفولته وشبابه، حيث تحف المكان أشجار الياسمين والنارنج التي تخيّلها معظم قرّاء الشاعر ومحبّوه.
هناك، جلس أبو المعتز وأم المعتز، بحسب قصائد صاحب “قالت لي السمراء” أيضًا؛ هناك اجتمع رجال الكتلة الوطنية لأكثر من مرّة خلال الانتداب الفرنسي، فوالد نزار كان وجيهًا في حيه وناشطًا سياسيًا، وعن هناك يقول الشاعر:
“في باحة الدار الشرقية الفسيحة، أستمع بشغف طفولي غامر، إلى الزعماء السياسيين السوريين يقفون في إيوان منزلنا، ويخطبون في ألوف الناس، مطالبين بمقاومة الاحتلال الفرنسي، ومحرّضين الشعب على الثورة من أجل الحرية، وفي بيتنا في حي (مئذنة الشحم) كانت تعقد الاجتماعات السياسية ضمن أبواب مغلقة، وتوضع خططٌ للإضرابات والمظاهرات ووسائل المقاومة. وكنّا من وراء الأبواب نسترق الهمسات، ولا نكاد نفهم منها شيئًا”. من نص “الولادة على سرير أخضر”.
البيت تم بيعه في ثمانينيات القرن الماضي، وكان نزار حيًا في ذلك الوقت، إلا أنه كان يقيم في لندن نظرًا لخلافاته المعروفة مع النظام السوري. عن البيع، يحدّثنا الكاتب الصحافي محمد منصور قائلًا: “بيت عائلة توفيق القباني، والد نزار قباني في حي مئذنة الشحم في دمشق القديمة، باعته العائلة منذ سنوات طويلة، حين انتقل بعض أفرادها للإقامة في حي أبو رمانة الأرستقراطي في الثمانينيات”.
الحقيقة أن محافظة دمشق لم تكن مهتمة بتخليد ذكرى نزار قباني، وإن أطلقت اسمه على شارع فرعي في حي أبو رمانة في أواخر عهد حافظ الأسد، ثم غضب عليه النظام بعد موته عام 1998 ومنعت بثّ أي شيء عنه وعن جنازته التي مشى بها الآلاف في دمشق.
البيت العربي القديم وسط حي الشاغور، يغيب اليوم بكل تفاصيله التراثية ومعانيه التاريخية للحركة الوطنية في سورية، وما أكسبه للشعر العربي من مخيلة نزار قباني؛ حيث لم يعد موجوداً إلأ بـ أسواره الخارجية فقط، فمُلاك البيت الجدد، وهم من عائلة نظام الدين العريقة في دمشق، والمعروفة بانتمائها وموالاتها لـ “محور المقاومة”، غيّروا شكله وأصبحت أرضه مرمرًا بأشكال حديثة وجدرانه بعضها من السيراميك، كما وضعوا مصعدًا كهربائيًا بين الطابق الأوّل والثاني.
في إيوان المنزل، حيث كان يجتمع رجال الكتلة الوطنية السورية، توضّح الصور أن رأس النظام السوري بشّار الأسد بات هو من يتصدّر المشهد في صورة له أعلى الجدار، وعلى يمينه صورة للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.
في حديثٍ لـ “جيل” مع أحد السكّان المجاورين لهذا البيت، يقول: “هناك هجمة إيرانية شرسة لتملّك البيوت والعقارات في دمشق القديمة، وقد استفحلت بعد التواجد العسكري لإيران ومليشيات حزب الله بعد الثورة أملًا في إحداث تغيير ديموغرافي، يسمح لهم بتغيير منبع الهوية في قلب دمشق في المدينة القديمة، وهو أمر سينهار ويفشل حتمًا ما إن ينهار التواجد العسكري الإيراني والمليشاوي بسقوط النظام”، لافتًا أن شراء منزل عائلة القباني لا يدخل ضمن هذه الحملة، إلّا أن حال المنزل اليوم يمثّل فرصة عائلة نظام الدين للتعبيرعن اصطفافها.
بعيدًا عن هوية مالك البيت الجديد وأسباب بيعه؛ السؤال الأهم هو لماذا لم تهتم بلدية دمشق أو وزارة السياحة أو مديرية الآثار والمتاحف في وزارة الثقافة بشراء البيت، وهل كان سيواجه مصيرًا أفضل أم أنه سيكون كحال منزل جدّ نزار مؤسّس المسرح السوري أبو الخليل القباني، الذي يصفه الباحث الاقتصادي العامل في وزارة السياحة السورية سابقًا يوسف حمامي بـ “الخرابة”، مستطردًا: “البيت كان خرابة اشترته وزارة السياحة ولم تُقم فيه أي نشاط ثقافي، حيث اختُلف على تحويله إلى متحف أو مطعم”.
العزاء الوحيد ربّما لأسرة الشاعر السوري الراحل نزار قباني، هو أن البيت لا زال مسكونًا ولا ينكر أصحابه تاريخه، حيث فتحوا أبوابه لـ تقبل عزاء القباني في نيسان/ أبريل 1998، وهذا يبدو أفضل على الأقل من أن يتحوّل إلى مطعم أو مقهى تراثي، ليبقى باب السؤال مفتوحًا، عن مصير إرث مئات المبدعين السوريين، ليس ما يتعلّق بمساكنهم فحسب، بل إنتاجهم الإبداعي وحقّهم من التكريم في الحياة والموت.
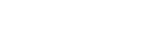




















أضف تعليق