المقبرة الرمزية للكتب، التي شيّدها الفنان محمد شرف في الساحة الترابية أمام معرض الهباب بأرض المعارض، هي عمل فني راق مشاكس رافض لهيمنة الأخ الأكبر، الذي يراقبك في رواية 1984 لأرويل، لساعات بسيطة فقط، وقبل أن تمتد يد الدولة المتسلطة لتزيل مشاغبة شرف الفنية، أوصل صاحبها رسالة شديدة إلى الكثيرين غير المكترثين للحالة المزرية للوضع الثقافي في الدولة. بالتأكيد فإن وزير إعلام “ندوة جلال الدين الرومي” وميليشياته في جهاز الرقابة، ومعهم مجلس الوزراء ومن نصب هذا الوزير في مكانه فوق رقبة حرية الضمير لن يفهموا رسالة محمد شرف، ولن يستوعبوها فهم حالة مستعصية بعجزها الأبدي في إدراك رسالة الثقافة والفنون، ودورهما الكبير في تحقيق مدنية وحضارة حقيقيتين وليستا حضارة الأسمنت والطوب وأكبر عمارة ومول تجاري.
هناك تصور بأن منع الكتب ليس قضية يجب أن تشغل بالنا اليوم، طالما يمكننا أن نحصل على معظم الثقافة الممنوعة من “الإنترنت”، والضجة حول المنع يراد بها إشغال الشارع العام عن هموم كبيرة، وهذا تصور غير صحيح وفي غير محله، فليست هي مسألة “إمكان أو عدم إمكان” بقدر ما هي قضية مبدأ الحرية بكل معانيها، الذي لا يصح معه أن نسلم رقابنا لجماعات رسمية غير مسؤولة تغط في جهل مركب، فالذي يمنع الكتب ويقرر ما هو صالح وما هو غير صالح لنا، وكأننا أطفال نلهو في حوش أبيه، هو من يمنع الفكر، ويضعه في زنزانة ما يجوز وما لا يجوز.
هذا الرقيب البائس هو ذاته حكماً من يقرر نوعية المناهج الدراسية البائسة التي تفرض على أطفالنا، هو من يحقن عقول الناشئة بمناهج ببغائية تدور في حلقة حفظ وتكرار الشكل والرسم بصورة مقدسة دون استيعاب المعنى، ويحرم النقد والجدل ورفض التسليم المطلق لكل ما يطرح، هو ذاته الرقيب الذي خنق أعمالاً فنية سابقة، ومثل دور المدعي العام والعشماوي في آن واحد في طلب وتنفيذ الإعدام للمسرح والفن، فأوقف عرض مسرحية “هذا سيفوه” للراحل عبدالحسين عبدالرضا قبل ثلاثين عاماً، وهو الذي منع وعدل وشوه أعمالاً فنية غيرها، هو الرقيب ذاته الذي يخنق أعمالاً فنية جميلة ناقدة، وفرض على مخرج مسرحي، مثل سليمان البسام، أن يلجأ لفرنسا وألمانيا لعرض مسرحياته التي لا تجد لها مكاناً في وطنه.
الفن والثقافة ليسا تزيداً ورفاهية، الفنون بكل صورها حربة في خاصرة الممارسة الفاشية لأي سلطة، الفن له رسالة تقول إنه يجب أن يكون مشاغباً ناقداً خارجاً عن المألوف والمتفق عليه اجتماعياً، ويذهب المفكر الألماني ادورنو لدرجة القول إن كل عمل فني هو جريمة غير مرتكبة، أي إنه يهز قناعات ومسلمات اجتماعية حين تصبح مستنقعاً راكداً يسبح فيه بشر يخشون الخروج منه، ويتصورون أن هذه هي الحقيقة، ولا شيء بعدها كجماعة كهف أفلاطون.
إلى متى يستمر هذا الحال البائس مع تلك العقليات المحنطة التي تفرض رأيها من الأعلى، وتجد صداها من الأسفل في الممارسة الاجتماعية، كما تظهر لنا في ثقافة “يا رب لا تغير علينا”؟! ماذا لو عملنا مقابر رمزية كمقبرة محمد شرف في كل مكان، تعد مسلخاً للحرية؟ هل توجد ساحة أمام مجلس الأمة؟! هل توجد ساحة أمام مجلس الوزراء؟ هل توجد ساحة في وجدان المتزمتين المحافظين…؟! كم نحن بحاجة إلى مقابر عميقة ندفن بها كل هذا الإرث السياسي الاجتماعي القمعي ولن نقرأ عليه الفاتحة؟
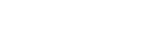




















أضف تعليق