التعليق على حكم محكمة الوزراء
الصادر بجلسة 8/3/2022 في القضية رقم 1/2021 محكمة الوزراء
بشأن ما يعرف بصندوق الجيش
إعداد المحامي/ فيصل صالح اليحيى
- المقررات التي تبناها الحكم تؤدي إلى الإخلال بالنظام الدستوري للدولة وزعزعة أركانه وتخل بالنظام المالي وموجبات الرقابة على المال العام وتهدم أركان العدالة وقواعد التقاضي والأثبات وتقوض سلطة المحاكم.
- لا يجوز لرئيس الدولة التصرف بالمال العام خارج الأطر والقواعد الدستورية أو خارج حدود الميزانية ومعرفته أو موافقته لا تجعلها بمنأى عن الرقابة.
- لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي وزير الدفع بعدم تحقق مسؤوليتهم السياسية أو القانونية بزعم الاستجابة لطلب الأمير.
- الإقرار بأن الأموال المصروفة غير مدرجة في الميزانية يستوجب المزيد من التشدد في الرقابة والمحاسبة على أوجه صرف تلك الأموال.
- لا أساس ولا سند لما قرره الحكم بأن لا رقابة على الأموال غير المدرجة في الميزانية العامة.
- تحربك القضية تم من خلال بلاغ وزير الدفاع الأسبق وهو ما يكفي لإسقاط الزعم بسرية أعمال المؤسسة العسكرية.
- الحكم لم يحمل المتهمين عبء نقض أدلة الإثبات وحمل جهة الإدعاء واجب الإثبات وهذا نقض لقواعد الإثبات.
- ما جاء بأسباب الحكم من مبررات يقع على درجة عالية من الخطورة.
كان للقضية المعروفة بقضية (صندوق الجيش) وما ارتبط فيها من أسماء وتخللها من ملابسات وإجراءات، وقع كبير في الشارع الكويتي الذي كان يراقب ويتابع تفاصيلها، وخير شاهد على ذلك ما صاحب صدور حكم محكمة الوزراء فيها من ردود أفعال كانت في معظمها تعبر عن الغضب والإحباط.
ولأهمية هذه القضية وما يرتبط فيها من أبعاد، وبعد قراءة متأنية للحكم المشار إليه، وإدراكا لخطورة ما قرره في أسبابه، واستشعارا لما تحمله هذه الأسباب من آثار وانعكاسات على النظام الدستوري والقانوني للدولة، وعلى حدود اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات السلطات، وعلى المال العام وموجبات الرقابة عليه، وجدت أنه من الضروري بل ومن الواجب – على أهل الاختصاص تحديدا – تناول هذا الحكم بالنقاش والتحليل والتعليق، سعيا واجتهادا في تلمس الحق، والتزاما بواجب بيان الرأي للناس وعدم كتمانه.
وبناء عليه استعرض في هذه الوراقة – المختصرة – الأسس والأسباب التي قام عليها الحكم، ثم أنتقل للتعليق عليها، وأختم بعرض تلخيص للنتائج والآثار التي يرتبها الحكم حال استقر هذا القضاء لدى المحكمة، وذلك على التفصيل التالي:
أولا: الأساس الذي قام عليه الحكم وما انتهى إليه من نتيجة في قضائه:
أسس الحكم قضاءه على سند من القول: “أن الأموال التي صرفت من الودائع والحسابات محل الإتهام قد تم تخصيصها والتصرف فيها بمعرفة المتهمين الأول والثاني وبمعرفة المغفور له صاحب السمو أمير البلاد الراحل في أمور تتعلق بالأمن القومي للبلاد ومصالحها العليا ولاعتبارات سيادية يجعلها بمنأى عن الرقابة عليها وعلى وجه صرفها… ومن ثم يكون ما قام به المتهمون قد تم تحت مظلة شرعية تحكمها إعتبارات سيادية لا سيما وأن تمسك المتهمين بالإنكار وامتناعهم عن الإفصاح عن حقيقة أوجه صرف تلك المبالغ… يجد سنده فيما تنص عليه المادة 14 من القانون رقم 32/1976 في شأن الجيش… والتي تحظر عليهم إفشاء أي معلومات تتعلق بعملهم وهو ما يشكل قيد يكبل حريتهم في ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم… فليس من الإنصاف وضعهم تحت مقصلة المساءلة جراء حرصهم على الحفاظ على أسرار الدولة العليا… وأن الرقابة على المصروفات السرية تنطبق على الأموال المدرجة بالميزانية، أما فيما يتعلق بالوقائع الماثلة فإن تلك الأموال لم تكن معلومة ومدرجة بميزانية وزارة الدفاع من الأساس… وأن هذه الأموال صرفت على أمور إرتأت القيادة العليا للدولة أنها “سيادية” وهو ما يخرجها من نطاق الرقابة… وأن ما قام به المتهمون من تصرفات في الأموال محل الاتهام وفق كتاب الديوان الأميري كانت تحت مظلة ما يبيحه القانون للموظف العام…”
ثم تناول الحكم بعد ذلك أدلة الإتهام وشهادة الشهود ورد عليها، لينتهي في قضائه إلى براءة المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم.
ثانيا: التعليق على ما جاء بالحكم من أسباب:
نشير بداية أن هذا التعليق غير معني بثبوت أو عدم ثبوت التهم المسندة للمتهمين، كما أنه لا يناقش أدلة الاتهام أو يقيمها ولا صحة أو عدم صحة الوقائع التي ذكرها الحكم، ومنها الكتاب المنسوب لرئيس الدولة، والذي دار عليه الكثير من الجدل.
ولكنه يتناول المقررات التي تبناها الحكم والمبادئ التي أسس عليها قضاءه، والتي يمكن أن تنطبق على أي واقعة في المستقبل، وذلك من خلال المباحث التالية:
– المبحث الأول: اختصاصات الأمير في التصرف بالمال العام.
– المبحث الثاني: مسؤولية الوزراء السياسية والجنائية.
– المبحث الثالث: حدود الرقابة على التصرف في المال العام.
– المبحث الرابع: اعتصام المتهمين بالسرية وامتناعهم عن الإفصاح عن أوجه صرف المبالغ.
– المبحث الخامس: قواعد الاثبات.
********
المبحث الأول: اختصاصات الأمير في التصرف بالمال العام:
قرر الحكم بأسبابه: “أن الأموال التي صرفت من الودائع والحسابات محل الإتهام قد تم تخصيصها والتصرف فيها بمعرفة وموافقة المغفور له صاحب السمو أمير البلاد الراحل في أمور تتعلق بالأمن القومي للبلاد ومصالحها العليا ولاعتبارات سيادية يجعلها بمنأى عن الرقابة عليها وعلى وجه صرفها…”
والحكم في الفقرة المشار إليها يقرر أن التصرف بالأموال العامة إذا تم بمعرفة وموافقة رئيس الدولة فإن ذلك يضفي عليه المشروعية ويجعله بمنأى عن الرقابة.
وهذا استخلاص فاسد ولا سند له، ويخالف أبسط القواعد المقررة بالدستور، ذلك أن اختصاصات الأمير التي يمارسها منفردا – في شأن إدارة الدولة – محددة على سبيل الحصر بنصوص المواد 4، 56، 61 من الدستور، المتعلقة بتزكية ولي العهد واختيار رئيس الوزراء واختيار نائب الأمير، وليس من بينها أي نص يسمح للأمير بالتصرف بالأموال العامة.
أما اختصاصاته التي يمارسها بواسطة وزرائه – وخاصة فيما يتعلق بالتصرف بالمال العام – فهي محكومة بنص المادة 144 من الدستور التي تقرر أنه: “تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون”، ونص المادة 146 التي تقرر أن: “كل مصروف غير وارد في الميزنية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون…”
ومن ذلك يتبين أنه لا يجوز لرئيس الدولة أن يتصرف بالمال العام خارج الأطر والقواعد الدستورية المشار إليها، أو خارج حدود قانون الميزانية، كما أن التصرف في هذه الأموال بناء على معرفة أو موافقة أو حتى طلب منه، لا يضفي على هذه التصرفات أي مشروعية، وهو حتما لا يجعلها بمنأى عن الرقابة.
وهذا الأمر ينقلنا إلى المبحث الثاني المتعلق بمسؤولية رئيس الوزراء أو الوزراء عن أعمالهم وتصرفاتهم التي تتم بناء على موافقة رئيس الدولة أو بطلب منه.
المبحث الثاني: مسؤولية الوزراء السياسية والجنائية:
جاء بأسباب الحكم أن: “ما قام به المتهمون من تصرفات في الأموال محل الاتهام وفق كتاب الديوان الأميري كان تحت مظلة ما يبيحه القانون للموظف العام…”، واستند الحكم في ذلك لنص المادة 27 من قانون الجزاء التي اعتبرت أن من أسباب الإباحة استعمال الموظف العام سلطته وتنفيذه لأمر تجب طاعته، معتبرا – أي الحكم – أن التصرفات بالأموال العامة محل التهام كانت مشروعة لأنها جرت في حدود استعمال السلطة الوظيفية أو تنفيذا لأمر من تجب طاعته وهو الأمير.
وهذا الاستخلاص من الحكم يطرح مسالة مسؤولية الوزراء فيما يقومون به من تصرفات، وعما إذا كان علم أو موافقة أو طلب رئيس الدولة كاف لإضفاء الشرعية على تلك التصرفات وتجنيب مرتكبها للمسؤولية السياسية أو الجنائية.
ومن الضروري الإشارة بداية إلى أن “تنفيذ أمر تجب طاعته” إن كان يعتبر من أسباب الإباحة بالنسبة للموظف العادي، في حدود القيود والشروط التي حددها القانون، دون أن يشوبها التواطؤ أو نية تحقيق مصلحة شخصية، وبعد اتخاذ الموظف للإجراءات القانونية اللازمة التي تعفيه من المسؤولية المترتبة على تنفيذ تلك الأوامر، وبإعتبار أن المسؤولية في هذه الحالة تقع على المسؤول الذي أصدر إليه هذه الأوامر، أقول إن هذا الأمر إن كان يعفي الموظف العادي من المسؤولية، فإنه حتما لا يعفي رئيس الوزراء أو أي وزير من تلك المسؤولية.
ذلك أن عناصر تلك المسؤولية – بالنسبة لرئيس الوزراء والوزراء – تدور حول نص كل من المادة 54 والمادة 55 من الدستور، حيث تنص الأولى على أن: “الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة”، في حين تنص الأخرى على أن: “يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه”
وتقرير هذين المبدئين في الأنظمة البرلمانية – كما هو مستقر في الفقه الدستوري – يفترض أن يكون (العرش كرسيا خاليا من الصلاحيات)،ولذلك فإن من يتولاه يكون غير مسؤول أمام أحد لأنه أصلا لا يتمتع بأي سلطة يمكن أن يحاسب عليها أو يسأل عنها.
إلا أن النظام الدستوري الكويتي كما يقول الدكتور عثمان عبد الملك – رغم تقريره للقواعد المتقدمة – لم يصل إلى حد تجريد رئيس الدولة من ممارسة أي سلطة حقيقية وجعله يسود ولا يحكم، كما هو مقرر في الأنظمة البرلمانية التقليدية، بل أبقى له على اختصاصات مهمة يمارسها بإرادته المنفردة بأمر أميري، وهي على سبيبل الحصر: تزكية ولي العهد (مادة 4) وحقه في اختيار رئيس الوزراء (مادة 56) واختيار نائب الأمير (مادة 61) فضلا عن مسرولية رئيس الوزراء والوزراء بالتضامن أمامه (مادة 58) دون أن يكون للأمير – وفقا للدستور – دور في الإدارة المباشرة لشؤون الحكم.
وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للدستور بقولها أن نص المادة 54 قد: “نأى بالأمير عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس كما أبعد عنه مسببات التبعية وذلك بالنص على أن رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه (مادة 55) وهم المسئولون عن الحكم أمامه (مادة 85) وأمام مجلس الأمة (المادتين 101 و102)”
ويوضح الدكتور محمد المقاطع هذه المسألة بالقول: “أن الأنظمة البرلمانية استلزمت أن يكون هناك شخص آخر إلى جانب الملك أو الأمير هو رئيس السلطة التنفيذية فعليا ويكون هو المسئول سياسيا وقانونيا عن أعمال حكومته وممارساتها في الدولة، حيث هناك ملك أو أمير يسود ولا يتمتع بصلاحيات حكم، وهناك رئيس وزراء هو يتولى تصريف شئون الحكم الخاصة بالسلطة التنفيذية… وتفريعا على ذلك نشأت فكرة ومبدأ أن رئيس الدولة يمارس صلاحياته وسلطاته بواسطة وزرائه الذين يتحملون المسؤولية نيابة عنه وبدلا منه، حيث أن تمتعهم بالسلطة يكون موجبا للمساءلة السياسية والقانونية وهو ما عكسته المادة 55 من الدستور المشار إليها سلفا.”
وهو ما أكده الدكتور عادل الطبطبائي بالقول: “أن الدستور يجعل من رئيس الدولة (الأمير) رئيسا للسلطة التنفيذية، ولكنه انسجاما مع النظام البرلماني الذي يعتنقه يجعل ممارسة رئيس الدولة للسلطة التنفيذية عن طريق الوزراء، وذلك لأن رئيس الدولة لا يسأل سياسيا بحكم أن ذاته مصونة لا تمس، مما يقتضي وجود جهة أخرى تتحمل المسؤولية عنه.”
ومن ذلك يتبين أنه إذا كان الأمير وفقا للنظام الدستوري الكويتي يستقل باختيار رئيس الوزراء، فإن الدور الذي يقوم به هذا الأخير يقع على قدر كبير من الأهمية فهو تقريبا الرئيس الفعلي للبلاد بما يتمتع به من صلاحيات واسعة وفقا للدستور، فهو المسؤول الأول عن اختيار فريق حكومته وتشكيل مجلس الوزراء الذي يعتبر – وفقا للمادة 123 من الدستور – المهيمن على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.
ولايجوز لرئيس الوزراء ولا لأي وزير – على ضوء ما تقددم – الدفع بعدم تحقق مسؤوليتهم السياسية أو القانونية تجاه أي إجراء يقومون به بزعم أن ذلك كان استجابة لطلب الأمير أو أنه تم بعلمه وموافقته، إذ أنه – وفقا لما قرره الدستور ومذكرته الإيضاحية – هم (أي رئيس الوزراء والوزراء) دون الأمير المسؤولون عن أعمالهم، وأن اتيان رئيس الوزراء أو أي وزير لأي عمل يعني أنه توافرت بحقه إرادة إرتكبه وبالتالي يكونون مسؤولين عنه.
وعلى فرض وجود رغبة أو طلب أو موافقة من الأمير لاتخاذ بعض الإجراءات، فإنه يكون على رئيس الوزراء أو الوزير المعني في حال عدم موافقتهم على تلك الإجراءات المطلوب منهم اتخاذها أن يتقدموا باستقالتهم نأيا بأنفسهم عن المساءلة السياسية أو المسؤولية القانونية، أما إذا لم يفعلوا، وقاموا بارتكاب هذه الأعمال فإنهم يكونون مسؤولين عنها سياسيا وقانونيا.
المبحث الثالث: حدود الرقابة على التصرف بالمال العام:
جاء بأسباب الحكم أن الأموال التي صرفت من الودائع والحسابات محل الاتهام قد تم: “لاعتبارات سيادية، يجعلها بمنأى عن الرقابة عليها وعلى أوجه صرفها…”
ويضيف الحكم في فقرة أخرى أن: “الرقابة على المصروفات السرية ينطبق على الأموال المدرجة بالميزانية، أما فيما يتعلق بالوقائع الماثلة فإن تلك الأموال لم تكن معلومة ومدرجة بميزانية وزارة الدفاع من الأساس… وهو ما يخرجها عن نطاق الرقابة…”
وهذا استخلاص ظاهر الفساد، وفيه خروج على مقتضيات المشروعية الدستورية والقانونية، ولنا على ما جاء بهذه الأسباب جملة من الملاحظات:
الملاحظة الأولى: يقر الحكم بأن الأموال محل الاتهام لم تدرج في الميزانية العامة للدولة، وهذا الإقرار يعني أن الصرف منها تم خارج إطار المشروعية الدستورية والقانونية المقررة للتصرف بالأموال العامة، والذي يستوجب أن يكون كل مصروف من الأموال العامة مدرج في الميزانية العامة للدولة التي يجب أن تصدر بقانون وفقا لنص المادتين 144 و146 من الدستور المشار إليهما سلفا، وهذا الإقرار يفترض أن ينبني عليه المزيد من التشدد في الرقابة على أوجه صرف تلك الأموال، والمصحوبة بالتشدد بالمحاسبة على صرفها خارج الأطر الدستورية والقانونية لمؤسسات الدولة.
الملاحظة الثانية: أن الحكم وضع إطار لحدود الرقابة على الأموال العامة، يتمثل في أن تكون هذه الأموال مدرجة في الميزانية العامة، فإذا كانت غير مدرجة فهي – بحسب الحكم – بمنأى عن الرقابة، وهذا الإطار – الذي وضعه الحكم – لا أساس ولا سند له، واعتماده يعني أن أي أموال يتم صرفها دون أن تكون مدرجة في الميزانية العامة ستكون بمنأى عن الرقابة حتى لو لم توصف بأنها (سرية)، باعتبار أن إطار الرقابة محدد بما هو مدرج في الميزانية العامة، وهذا فيه هتك وهدر لمقتضيات وموجبات الرقابة على المال العام، كما أنه يحمل تناقضا صارخا بين ما يقرره الحكم وما يترتب عليه من نتيجة، وهو ما نبينه في الملاحظة التالية.
الملاحظة الثالثة: رغم أن الحكم يقر بمشروعية الرقابة على المصروفات السرية المدرجة في الميزانية (فقط)، إلا أنه يجعل من عدم إدراج المصروفات محل الاتهام في الميزانية العامة – والذي يعد بحد ذاته مخالف للمشروعية كما سبق البيان – سببا في عدم انطباق الرقابة عليها!! وهذا استخلاص فيه قلب لمنطق الأمور، ذلك أنه إذا كانت المصروفات السرية المدرجة في الميزانية خاضعة للرقابة – وهي كذلك وفقا لما قرره الحكم – فإن المصروفات التي تمت خارج إطار الميزانية تكون أولى بالرقابة وجديرة بالإدانة، باعتبار أنها صرفت ابتداء خارج إطار المشروعية ودون سند من القانون. إلا أن الحكم يجعل من عدم إدرج تلك المصروفات في الميزانية – والذي تم بالمخالفة للقانون – سببا لعدم إخضاعها للرقابة، وهو ما يكشف التناقض الذي شاب الحكم.
الملاحظة الرابعة: أن الهدف من الرقابة المالية هو التقصي عن المخالفات، والتأكد أن الأموال العامة صرفت في حدود ما خصصت له وضمن الأطر القانونية المقررة لذلك، وبالتالي فإن جزء رئيسي وأساسي من أعمال الرقابة هو اكتشاف ما إذا كانت هناك أموال تم التصرف فيها خارج إطار قانون الميزانية العامة وبالمخالفة للمقرر فيه، باعتبار أن هذا الأمر بحد ذاته يعد مخالفة، ثم البحث في أوجه صرف هذه الأموال، في حين أن الحكم يجعل من عدم إدراج الأموال محل الاتهام في الميزانية – الذي يعد مخالفة – سببا في عدم إخضاع أوجه صرفها للرقابة!!
ولا يغير من ذلك ما جاء بالحكم من تعليلات غير منضبطة وفضفاضة مثل “سرية الاعتبارات السيادية المرتبطة بالمصلحة العاليا للبلاد”، فهذا التعليل لا يجعل من الصروفات طليقة من كل قيد وبمنأى عن أي رقابة، بدليل أن الميزانية العامة للدولة مخصص فيها مصروفات “سرية” لاعتبارات “سيادية” تتعلق “بالمصلحة العليا للبلاد”، ومع ذلك فهي خاضعة للرقابة.
فما الذي يجعل المصروفات “السرية” المدرجة في الميزانية العامة خاضعة للرقابة بإقرار الحكم، في حين أن ذات الحكم يجعل المصروفات الغير مدرجة في الميزانية – بالمخالفة للمشروعية الدستورية والقانونية – غير خاضعة للرقابة؟! وما سند هذا التفريق بين هذين النوعين من المصروفات؟!
المبحث الرابع: اعتصام المتهمين بالسرية وامتناعهم عن الإفصاح عن أوجه صرف المبالغ:
جاء بأسباب الحكم أن: “تمسك المتهمين بالإنكار وامتناعهم عن الإفصاح عن حقيقة أوجه صرف تلك المبالغ حال كونهم تابعين للمؤسسة العسكرية…، يجد سنده فيما تنص عليه المادة 14 من القانون رقم 32/1976 في شأن الجيش والتي تحظر عليهم إفضاء أي معلومات تتعلق بعملهم…، وهو ما يشكل قيدا يكبل حريتهم في ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم، وهو ما تأباه العدالة…، فليس من الإنصاف وضعهم تحت مقصلة المساءلة الجنائية جراء حرصهم على الحفاظ على أسرار الدولة العليا…”
وكان نص المادة 14 من القانون رقم 32/1976 المشار إليها والتي استند عليها الحكم في قضائه قد نصت على أنه: “يحظر على العسكري أن يفشي أية معلومات تتعلق بعمله بعد إنتهاء خدمته بالجيش”
وهذا استدلال ظاهر الفساد والبطلان، ذلك أن التزام الموظف بالسرية هو أمر مفترض، ويشمل كل عمل يُمكن صاحبه من الاطلاع على معلومات ذات طبيعة سرية، فهو غير قاصر على العسكريين فقط، بل يشمل الموظفين المدنيين أيضا، حيث يقابل نص المادة 14 من قانون الجيش – المشار إليها – نص المادة 25 من قانون الخدمة المدنية رقم 15/1979 التي تقرر أنه: “يحظر على الموظف: 1)….. 2)….. 3)….. 4) أن يدلي بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة… ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.”
إلا أن هذه السرية لا تحجب – ولا يفترض أن تحجب – جهات التحقيق والمحاكم على وجه الخصوص، من حق الإطلاع على البيانات والمعلومات اللازمة للفصل في أي قضية تعرض عليها، خاصة إذا كانت هذه القضية تتعلق بذات المعلومات التي تعتبر “سرية” وترتبط ارتباطا مباشرا بمحل الاتهام، فلا يجوز للمتهم في هذه الحالة التحجج بالسرية في مواجهة المحكمة. ولو قلنا بغير ذلك للاذ كل موظف متهم بزعم “السرية” لتكون مخرجا له من أي اتهام، وهذا أمر لا يستقيم من المنطق القانوني السليم، بل يهدم أركان العدالة وقواعد التقاضي ويقوض سلطة المحكمة.
فضلا عن ذلك فإن تحريك هذه القضية بالأساس تم من خلال البلاغ المقدم من وزير الدفاع الأسبق، والتي تقع الأموال محل الاتهام تحت مسؤوليته، وهذا بحد ذاته يكفي لإسقاط الزعم بالسرية، ذلك أنه لا يستقيم مع المنطق القانوني السليم أن يعتصم المتهمين – ومنهم موظفين بالوزراة وتابعين للوزير – “بسرية أعمال المؤسسة العسكرية” في حين أن مقدم البلاغ هو المسؤول الأول عن تلك المؤسسة بصفته وزيرا للدفاع.
إلا أن اللافت في الأمر أن الحكم لم يكتف بإقرار حق المتهمين بالامتناع عن الإفصاح عن حقيقة أوجه صرف المبالغ محل الاتهام (التابعة لوزارة الدفاع والمقدم عنها البلاغ من وزير الدفاع نفسه) بل إنه اعتبر امتناعهم سببا يستحقون عليه الثناء لـ”حرصهم على الحفاظ على أسرار الدولة العليا…”!!
المبحث الخامس: قواعد الاثبات:
جاء باسباب الحكم – في معرض نقاشه وردة على أدلة الاتهام – أن: “المستفاد من أقوال الشهود أن الأموال محل الاتهام كانت بالأساس عبارة عن ودائع أنشأتها الحكومة… وتم نقل تبعيتها إلى وزارة الدفاع… إلا أن تلك الأموال لم تدرج في الدفاتر الرسمية والميزانيات المتلاحقة… ولم تتمكن اللجنة (لجنة التحقيق) من الكشف عن الغموض الذي إعترى وأحاط بتلك الودائع… كما لم تتوصل اللجنة إلى المصدر الأساسي لتلك الأموال وسبب عدم إدراجها في الميزانية والآلية المتبعة لمنح التفويض في التعامل عليها… كما أن اللجنة المشكلة لفحص الحسابات لم تقم بالانتقال إلى مقر المكتب العسكري بلندن لفحص ما عسى أن يوجد به من مستندات متعلقة بالدعوى والاطلاع على كافة الحسابات التي تم فتحها بصورة غير رسمية وآلية تسليم إدارة تلك الحسابات… وأن اللجنة (لجنة التحقيق) لم تستدل أو تتبين إلى من آلت إليه تلك المبالغ، كما ثبت بالتقرير أن بعض الحسابات التي تم التحويل إليها هي حسابات غير محدد فيها اسم المستفيد، وأن بعض هذه الحسابات شابها بعض الغموض والذي عجزت اللجنة عن إيضاحه… وأن المبالغ التي اثبت تقرير اللجنة تحويلها إلى الحسابات غير الرسمية… قد اقتصر فيها التقرير على تحويل المبالغ إلى تلك الحسابات ولم يبين ما آلت إليه هذه المبالغ… ولمن آلت إليه… للوقوف على المستفيد الأخير من هذه المبالغ…”
ويضيف الحكم أنه: “بالنسبة للعقارين اللذين تم بيع أولهما لشركة تعود ملكيتها للمتهم الأول وزوجته، وثانيهما إلى شركة تعود للمتهم الثالث وزوجته… فقد خلت الأوراق من بيان أسس التقديرات الفعلية للعقارين وقت بيعهما والقيمة السوقية لهما آنذاك، كما أن افتراض أن قيمتها قد زادت وقت البيع عن وقت الشراء هو تمكين لا يصلح في أصول الاستدلال…”
لينتهي الحكم من كل ذلك إلى القول أنه: “من جماع ما تقدم يكون تقرير اللجنة قد شابه العديد من أوجه القصور وعجز عن الكشف عن الصورة الحقيقية لواقع الأمر بالنسبة للأموال محل الاتهام وكيفية التصرف النهائي فيها وشخص من آلت إليه…”
وما جاء بأسباب الحكم – على نحو ما تقدم – ينقض القواعد الواجب اتباعها في إثبات أو نفي التهمة، ذلك أنه وإن كان المطالب ابتداء بإثبات ارتكاب الفعل المؤثم هي جهة الإدعاء، إلا أنه متى نجحت هذه الجهة في تقديم أدلة وقرائن معتبرة على ارتكاب الأفعال المؤثمة، فإن عبء نفي ارتكابها في هذه الحالة ينتقل إلى المتهم، الذي عليه الرد على تلك الأدلة والقرائن وتفنيدها.
فعلى سبيل المثال إذا أقامت جهة الإدعاء دليلا يثبت أن شخصا من الأشخاص تصرف بأموال عامة على نحو غير معلوم أو لجهات مجهولة، فإنها غير ملزمة بعد ذلك بإثبات الكيفية التي تم التصرف بها بهذه الأموال ولمن آل إليه، ليتنقل عبء الإثبات في هذه الحالة إلى المتهم الذي عليه الرد على هذه الأدلة من خلال إثبات مصارف تلك الأموال ولمن آلت إليه.
لما كان ما تقدم، وكان ثابتا – بحسب الحكم – أن الأموال محل الاتهام “لم تدرج في الدفاتر الرسمية والميزانيات المتلاحقة”، ولم يتبين “المصدر الأساسي لتلك الأموال وسبب عدم إدراجها في الميزانية والآلية المتبعة لمنح التفويض في التعامل عليها”، وأن هناك “حسابات تم فتحها بصورة غير رسمية ولا يعرف آلية إدارتها”، وأنه غيرمعروف “إلى من آلت إليه تلك المبالغ”، وأن “بعض الحسابات التي تم التحويل إليها غير محدد فيها اسم المستفيد”، وبعضها “شابها الغموض” وأن هناك “مبالغ اثبت تقرير اللجنة تحويلها إلى الحسابات غير الرسمية”
وهذا القدر من المعلومات يثبت وقائع محددة تتمثل في وجود أموال عامة تم التصرف فيها خارج الأطر الرسمية المقررة، ولا يعرف مآلات صرفها، وثبوت هذه الوقائع يكفي لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهمين الذين يفترض عليهم أن يبينوا للمحكمة مصدر الأموال محل الاتهام وسبب عدم إدراجها في الدفاتر الرسمية والميزانيات المتلاحقة والآلية المتبعة لمنح التفويض في التعامل عليها، ويكشفوا حقيقة الحسابات غير الرسمية وسبب فتحها وآلية إدارتها، ويوضحوا بالدليل إلى من آلت إليه المبالغ محل الاتهام في ظل ثبوت واقعة صرفها لجهات غير معلومة خارج الأطر الرسمية وعدم وضوح مآلها.
إلا أن الحكم لم يحمل المتهمين عبء نقض أدلة الإثبات، بل حمل جهة الإدعاء واجب إثبات إلى من آلت إليه المبالغ محل الاتهام لمعرفة المستفيد الأخير منها، وهذا – يعد من الحكم – نقض لقواعد الإثبات وخروج على مقتضياتها.
ومن ذلك ما ثبت من بيع عقارات لشركة تعود ملكيتها لبعض المتهمين بسعر أقل من سعر الشراء، فهذه الواقعة بحدها الأدنى – وبغض النظر عن إضرارها أو عدم إضرارها بالمال العام- تتصادم بشكل صارخ مع نص المادة 131 من الدستور التي تحظر على الوزير شراء مالا من أموال الدولة أو بيعها شيء من أمواله لما في ذلك من شبهة تعارض المصالح، وهذ الشبهة تتعاظم في ظل ما هو ثابت من أن سعر بيع تلك العقارات للشركات التابعة للمتهمين كان أقل من سعر شرائها.
إلا أن الحكم – الذي أثبت هذه الوقائع ولم ينفها – لم يحمل المتهمين عبء إثبات نقضها، بل ذهب إلى القول بأنه: “خلت الأوراق من بيان أسس التقديرات الفعلية للعقارات… وأن افتراض أن قيمتها قد زادت وقت البيع عن وقت الشراء هو تخمين لا يصلح في أصول الاستدلال…”
ومن كل ما تقدم يتبين أن الحكم قد خالف قواعد الإثبات، وأنه رغم إقراره وعدم نفيه لكثير من الوقائع المشار إليها سلفا، إلا أنه أحل المتهمين من الرد عليها ونقض الأدلة والقرائن المساندة لها، مرة بداعي “سرية” المعلومات التي سبق التطرق لها، ومرة من خلال تحميل جهة الإدعاء عبء إثبات ما يقع على عاتق المتهمين عبء إثبات نفيه.
ثالثا: النتائج والآثار التي يرتبها الحكم في حال استقر هذا القضاء لدى المحكمة:
إن ما جاء بأسباب الحكم من مبررات وما انتهى إليه من نتيجة يقع على درجة عالية من الخطورة، ذلك أنه:
- يمنح رئيس الدولة سلطة التصرف بالأموال العامة – دون سند – حتى لو لم تكن مدرجة في قانون الميزانية، ويضفي المشروعية على تلك التصرفات طالما أنها تمت بمعرفته أو موافقته أو بطلب منه.
- يحجب المسؤولية القانونية والجنائية عن رئيس الوزراء والوزراء طالما أن أعمالهم تمت بعلم أو موافقة أو طلب رئيس الدولة، حتى لو كانت تلك الأعمال تمثل فعلا إجراميا، باعتبار أن قيامهم بهذه الأعمال يدخل في أسباب الإباحة كونها تأتي تنفيذا لأمر تجب طاعته، وذلك بالمخالفة لطبيعة المركز القانوني الذي يحتله كل من رئيس الوزراء والوزراء.
- يحجب الرقابة على المصروفات غير المدرجة في الميزانية العامة للدولة سواء كانت سرية أو غير سرية.
- يقررحق المتهم بالاعتصام بسرية المعلومات وعدم الافصاح في مواجهة القضاء وجهات التحقيق في وقائع لازمة للفصل في القضية وتتعلق بذات المعلومات التي يعتبرها المتهم “سرية” وترتبط ارتباطا مباشرا بمحل الاتهام، حتى لو كان مقدم البلاغ هو الوزير التي تقع الأموال محل الاتهام تحت مسؤوليته، معتبرا – أي الحكم – أن اعتصام المتهم بالسرية يستحق الثناء كونه يشكل التزاما عليه يفرضه القانون.
- ينقض قواعد الإثبات ويخرج على مقتضياتها ويحل المتهم من إثبات براءته رغم ثبوت ما يكفي من الأدلة والقرائن على ارتكابه للفعل المؤثم، مرة بداعي “سرية” المعلومات، ومرة من خلال تحميل جهة الإدعاء إثبات ما يقع على عاتق المتهم عبء إثبات نفيه.
وهذه المقررات – التي تبناها الحكم واتخذها سندا لقضائه – تؤدي إلى الإخلال بالنظام الدستوري للدولة وزعزعة أركانه، على مستوى الصلاحيات والمسؤوليات المقررة لكل من رئيس الوزراء والوزراء، كما أنها تخل بالنظام المالي المقرر بالدستور، وموجبات الرقابة على المال العام، فضلا عن أنها تهدم أركان العدالة وقواعد التقاضي والإثبات وتقوض سلطة المحاكم.
إن المساحة المتاحة للكتابة تقصر عن بيان الكثير من الجوانب المتعلقة بالحكم المعروض، والذي نرى أنه إذا ما استقر وتأيدت أسبابه سيرتب حالة من عدم اليقين القانوني يصعب التنبؤ بمداها وأثرها.
ويبقى أن نقول – وعلى الهامش – أنه من الضروري الإشارة إلى أن “للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن” كما تنص المادة 17 من الدستور، وأن هذا الواجب يفوق – من الناحية الشرعية والأخلاقية والقانونية – ذريعة “السرية” المزعومة، أو واجب طاعة الأوامر – إن وجدت أصلا – وأيا كان من أصدرها.
تم بحمد الله،،،
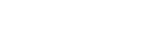




















أضف تعليق